مقدّمـة:
عِندما قدّم المُؤرّخُ “عبدالله حنّا” كتابهُ القيّم حولَ الحركاتِ العَاميّة، وبالأخصِّ ما شَهدهُ “جَبلُ حَوران” /1888/، كانَ قَد فتحَ بَاباً مُشرّعاً لِمجموعةِ رُدودٍ نقديّةٍ مُختلفة، حتى أنّ نُقّادهُ اختلفوا وتباينوا، وتميّزت ردودٌ دونَ أُخرى، كان أبرزها ردّ الأستاذ “رضوان رضوان” عبرَ دراسةٍ مُوسّعة أُلحِقتْ -لقيمتها- بالكتابِ المَنقودِ ذاته، فنقدُ “رضوان” صارَ يُوازي المتنَ الأساسيّ لِحنّا ولا يقلُّ قيمةً علميّةً عنهُ، بينَما افتقدت باقي الرّدودُ للمَنهج، واعتمدت المآثرَ الشَفويّة، ولَمْ تَجرؤ على الوقوفِ مَوقفاً نَقدياً تجاه ذاتها، واستهوتها النّزعةُ الغِنائيّة المُمجِّدة.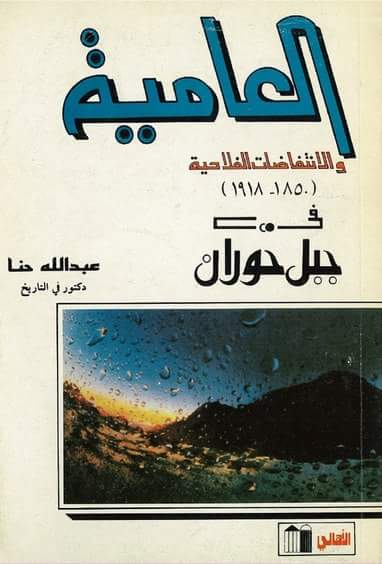
أمّا مُلخّصُ الاختلافِ بينهما، فيمكنُ إيجازُهُ بأنّ “حنّا” طَبّقَ مَنهجه المَاركسيَّ قارئاً الصّراعَ الطّبقي، دُونَ أن يُقيمَ أي دورٍ للعاملِ الجّغرافي، وهذا ما انتبه إليه “رضوان” مُعتمداً على نظريّة “التحدّي والاستجابة” التي قال بها المؤرّخ “آرنولد توينبي”، ليَخلُصَ إلى أنّ مُجتمعَ “السويداء” قُبيل العاميّة كانَ “مُجتمع نُخبة” لأنّ آليّات الهجرة والارتحال إليهِ عَملت بقوّةٍ محفّزة على استيطانِ الجبلِ وإعماره.
أوّلاً | الجغرافيا ورواية المكان:
عن الدارِ العربيّة للعلوم “ناشرون”، صَدرت رواية “سنة العصافير”/شكيب أبو سعده (360 صفحة).
تَحفلُ الرّواية بالمكانِ وتفاصيله، إذ لا تَترك مَعلماً أو جِهةً من جِهات الجبلِ الأربع (المقْرَن كما تلفظ بالعامية) إلا وتفردُ لها مساحةً في فصولها الأربعة والعشرين، ولمّا كانَ لابدّ للمكانِ من زمانٍ يستوعبه، فإنّ الصّراعَ المَرير لشخصيّات الرّواية مع الجُغرافيا والطّبيعة، أعادَنا إلى زمنٍ غابرٍ نَبتعد عنهُ اليوم مئة عامٍ أو أكثر، لأنّ الرّواية تنتهي مع إعلان الثورة /1925/.
وعليه، اكتمَلت شُروط التّصنيف دونَ أيّ مُقاومةٍ من النص، إذ لم تُشعِرنا الرّواية بأنّها تسيرُ ضدّ عمليّة التّأطيرِ تلك، بَلْ عَلى العكسِ تماماً، فكأنّما الرّواية تَسعى لتصنيفِ ذاتها بذاتِها.
هي روايةٌ تلعبُ على تيمةِ المَكان، وتُدوِّرنا بإجهادٍ مع البيئاتِ الضَيّقة، تيمةٌ لَها انتشارٌ ورواجٌ على صعيد الرّواية العربيّة الرّاهِنة.
كَما عمِلت الرّوايةُ على تقديمِ شَخصيّاتها بوصفِهم أبطالاً، ينتمون لعائلةٍ واحدة، يرتفعُ الجدُّ فوق الرؤوس، ويتوزّع “الرجالُ” باقي المهام، لتظهر المرأة ضمنَ قالبٍ مثاليٍّ واحد يطمسُ الشخصيّة النسويّة المُستقلة والمتميّزة عن غيرها.
هناكَ نِساءٌ بالرواية يُمكِن إجمالهنّ بكبسولةٍ واحدة، لكنّ تمييز امرأة بينهنّ، فاعلة على مدارِ الحدث هو أمرٌ صعب، عُدنا إذن لمقولةِ “مُجتمع النخبة” وهل أسهلُ من الكلام عن مجتمعٍ كل أفراده نخبويّونَ وأبطال؟، حتّى “الطبيعة” العَدوُّ الأساسيُّ في الرّواية لا تلبثُ أن يتمّ تطويعها بين أيديهم، أمّا باقي ما يعترضُ الأبطالَ وسائر الحكايات فإنّ ذلك لا يَحضر، لا نشهدُ صراعاً داخل هذا المُجتمع (إلا مع الخونة)، ولا مَواقف إشكاليّة يتردّدُ الكاتبُ قبل حَسمها، ولو أنّ النهايات المفتوحة -حيث رست الرواية أخيراً- خفّفت وطأة ذلك التدخّل.
بالعودةِ قليلاً إلى المُقدّمة، نجدُ مقولة “مجتمع النّخبة” -عند رضوان- قد وَردت في سياقِ قراءةِ صراعٍ عنيفٍ بين طبقات مجتمعٍ واحد، لم تعصمهُ لا وحدتهُ الجغرافيّة ولا الدينيّة (كما لم تَعصم مجتمعاتٍ أخرى) عن خوض صراعٍ حول مُلكيّة الأرض، وإعادة توزيعها، لا للانتصارعلى قوى الطبيعة وحسب.
ثانياً | مآلُ الرحلة:
تخترقُ الرّواية ثلاث رحلاتٍ أساسيّة تتمحورُ حولها الأحداث، وتتفرّع عَنها رحلات أهميّتها نسبيّة, وبتجميعها يتمّ البناءُ السّرديُّ كاملاً.
الرّحلةُ الأولى التي قامَ بها “أسعد الغريب” (والد البطل نجم الغريب) لاسترداد دَيْنه، انتهت بموتهِ نتيجةَ الصّقيع، فأُصيب بالـ”غرغرينا” ورَفَضَ قطع قدمه، لأن مُعتقدهُ الدّيني يُوحي إليه بأنّ أُمّاً جديدة تنتظره.
بهذهِ الرّحلة يُقدّم الكاتب نموذجاً مِثالياً لبطلِ الرّواية، حضور أَبويٌّ طاغٍ لا فَكاك منه يُورّثُ القَدريّة والتسليم جيلاً بعد جيل.
أمّا الرّحلة الثّانية التي منها أخذت الرّوايةُ عنوانها (سَنَةُ العَصافير)، فتنساب فيها أفكارٌ إنسانيّة تحاول الابتعاد عن نمطيّة البطولة، بل تُحاول تقديم جوابٍ جديدٍ لسؤال: (من أين جاء البطل ببطولته؟)، وكان يُمكن بناءُ نموذجٍ آخر ومختلف عن معنى البطولة، يتمركز حول إنقاذ عائلة الغريب لقطيعها بعد ثلج نيسانَ المفاجئ، والعودة بهِ إلى المَضارب، ومجموعةُ العواطف المُرافقة لمشهدِ الإنقاذ الطويل، وكيفَ أنّ (نجم) هَالَهُ مَنظرُ الموت الذي حَصدَ آلافَ العصافير وألقاها على وجهِ الثّلج، أيّ جيشٍ فعلَ هذا؟، كانَ يَمكن حقاً لهذا الفصل أن يبني مفهوماً آخرَ للبطل، كما قام بتشييد وإعطاءِ الرّواية اسمها الفريد.
واللافتُ، لولا أنّ الرحلة الثالثة قَطَعت هذهِ السيرورة وأعادتنا لكلاسيكيّات البطولة حيث الخيولُ المُطَهّمَة، والخناجر المطويّة، ترافق (نجم) في رحلته إلى وادي القرن وتتابع تحوّله إلى صعلوكٍ نبيلٍ أشبهَ بـ”روبن هود”.
هُنا بَدَت غايةُ الرّحلة ليسَ الالتفات نحو الآخر، الذي يَهزّ قناعات البطل أو صاحب الرّحلة ويفتحُ المَجال أمامَ الكاتب ليبثّ عُقداً روائيّة تُغني النّص، وتَذهبُ بالقارئِ إلى عالمٍ مُختلف، وهو ينتظرُ حلّاً لها، إنّما جاءت هذهِ الرحلات مجرّد انتقال بين وحدات “إثنوغرافية” تبحثُ عن المتشابه، الّذي لا يفصلنا عنهُ بمعايير اليوم سوى سويعات قليلة بالسيّارة، عند هذا الحدّ نستطيع القول: إنّ العصافير بدورها تشهدُ على رحلاتنا الضيقة، لا نحن فقط نتّهمها بذلك!.
لا شكّ بأنّ لُغة أي قوم، نُحِتَتْ بما لا يتعدّى مَجالهم الجغرافي، وأنّ مَهمّة تقديمِ هذا المجال روائياً هو جزءٌ من الجدليّة القائمة بينَ هذين الطرفين، فالعربُ مثلاً، عندما كانت تَعدُّ الأسماء الخمسمئة للناقة أو للأسد، لم تكن لتبالغ بطبيعة الحال، إنّما هي الضّرورة.
هذهِ الوِفرة تضعنا ضمنَ إطارٍ مريحٍ وحميمي مع “اللغة/اللهجة” التي نألفها ونعرفُ ألغازها ومجاهيلها، وتُحقّق دهشةً غرائبيّةً لدى “الآخر/القارئ/المستمع”.
أكثر ما اتضحت هذه السّمة خلال الروايات ذات السّمة المكانيّة البارزة، ورواية (سنة العصافير) صَنّفت ذاتَها كَما قُلنا ضمن هذا النسق، وبالرّغم من البناءِ اللغوي الفَصيح والسّلس على لسان الرواي، إلا أنّ مَدخَلات اللهجة البدويّة كانت لسانَ حالِ الشخصيّات الأقربَ إلى عواطِفها عندما تُنشدُ بحماس، أو تحتدمُ بانفعال، أو ترثي ذاتها.
إنّ الحسّ بهذهِ المُفارقة أفاد منه الكاتب وبثّهُ خلال عباراته بكل سهولة، لكنّ اللغة أيضاً كما الشخصيّات، لم تَستطع أن تتحرّر من عبءِ المكان وثقلِ الجُغرافيا المُطبقة عليها بينَ جبلين “عنوان لأحد الفصول”.
فحتى لو عدّدتَ خمسمئة (اسم) لشيءٍ بعينه، أنتَ بالمقابل تفرّط بخمسمئة (شيء) لا تحيطُ به علماً، عبر هذا نضعُ يَدنا على الفارق “المعرفي/الثقافي” بين القارئ المُعاصر والشخصيّات الماضية.
“هل نَقصُّ التاريخ لأجل التاريخ؟” ، إنّه الفارقُ بين زمنين ولغتين، ومشاكل وإشكاليات لا تلتقي إلا بفعلِ عمليةِ إسقاطٍ قسريٍّ يَتجرّأ عليها القارئ، إذ تَخلّى الراوي عن البوح المُباشر بها.
خاتمة (ليس جبلاً):
ليسَ جبلاً بالحقيقةِ وليست الحكايات، وقبل مائة عامٍ أيضاً، فَاضلَ “محمد كردعلي” حضارياً بين دروز حوران، ودروز لبنان.
قالَ: (إنّ الدروز أخذوا يَرجِعون إلى أخلاقِ البادية، بسببِ هِجرتهم إلى جبلِ حوران، بعدَ أن كادوا يَدخلون في الحضارة مِنَ اللُبنانَين الغَربيّ والشرقي).
مَاتت هذهِ المُفاضلة مَع موتِ الدّولةِ العُثمانيّة، بَل مع موتِ الزّمن العُثماني الإقطاعي، وطريقة وَعي المَدَنيّة آنذاك مُختلفة عمّا هيَ عليهِ اليوم بَعد مئةِ عام.
هذا ولم نَقُل شيئاً بعد، عن ديناميّات التحضير الخاضعة لها المدينة، فجبل حوران اليوم ليس على حُدودِ البادية كما كانَ يَنظر إليهِ المَركز الاستانبولي “الباب العالي”، إنّما الأصحُّ القولَ بأنّه على بُعدِ ساعةٍ واحدةٍ فقط عن دمشق، والطريقُ الدولي المُعبّد الذي يَصله بِها، ويخترقهُ “من الصَّوَرة حتى عَنْز”، يُذلّل الصِفة الجُغرافيّة لكلمةِ “جَبَلْ” أصلاً، ودمشق بِدورها ليسَت تلكَ الولاية العثمانيّة النائِيَة، هُنا نُلاحظ الاضطراد، فَكُلّما كَانَ نَصيبُ دِمشقَ مِنَ المركزيّة السياسيّة والدولَتيّة أكثر، سَاهَمَتْ في جَرّ وتَطويعِ مُحيطِها سَهلاً وجَبلاً ومَا هُو أبعد، إلى دائرةِ الحَضارة والمدنيّة، هَذا ما فَعلَته تاريخيّاً، رغم فَتراتِ الانقطاع الطارئة، وبالتّالي اعتراضُ التحديثِ بالـ”نوستالجيا” إنّما هُوَ أَسفٌ على الخيولِ المُطهمة, والخناجر المَطويّة، (أو حتّى حِلَلُ اللحوم المصريّة، حسب التعبير السَّاخر لـكارل ماركس).
بَعدَ كُلّ هذهِ السَردة، نعودُ إلى مَقولةِ “كردعلي”، ماذا نجد منها؟، باختصار: لاشيء.
بل إنّ الوعي (المقاطعجي) ظلّ مُكرَّساً وأكثرَ فَتكاً في “جبالِ لبنان” مِمّا هُوَ عليهِ في “جبل حوران”.
أخيراً: إنّ فِكرةً عَصريةً كهذه، لا تَغيبُ عن الرّوايةِ بِعينها فقط، بَلْ هي فَخٌّ لِسائرِ اللاعبينَ على تيمة المكان -أي مكان- في الأدب والسّياسة، وكأنّ لا مَكانَ إلّا مَا هُو: ماض.

